عبد المنعم علي عيسى :

تقول وثائق التاريخ أن تكوينها يعود للألفية الثانية ، أو الثالثة ، قبل الميلاد ، أما الجغرافيا التي وضعتها على ضفاف نهر العاصي فتقول أن ما لم يتكشف من تلك الوثائق يجب أن يعود بها إلى عهود أقدم أسوة بكل الحضارات التي نشأت على ضفاف الأنهار وعلى شواطئ البحار ، وهذا يفترض فيها أنها ” جايلت ” نظيراتها اللواتي قمن على ضفاف الرافدين ، دجلة والفرات ، التي يعود قيامها ، الموثق ، لعشرة آلاف عام على أقل تقدير ، خصوصا أن المسافة ، الجغرافية ، التي تفصلها عن هذه الأخيرة لا تزيد عن بضع كيلومترات ، وهي لا تحتاج لكل تلك الفترة المديدة التي تقارب السبعة ، أو الثمانية ، آلاف عام لكي تنذري ” نارها ” فتصل العاصي .

تعاقب عليها الآراميون ، الذين أطلقوا عليها اسم ” حامات ” التي تعني بلغتهم الحصن أو القلعة ، ثم الحيثيون والفراعنة ، وفي العام 1000 ق .م دخلت في حوزة النبي داؤود ( ع ) وبقيت فيها إلى أن جاءها الإسكندر المقدوني في العام 320 ق . م وظلت تحت حكمه إلى أن استولى عليها الرومان عام 64 م ، وفي العقد الرابع من القرن السابع الميلادي باتت تحت الحكم العربي الذي استمر فيها إلى الآن ، وهي شهدت ما شهدته باقي نظيراتها السوريات خلال المدة الفاصلة بين 1258 ، الذي شهد غزو المغول للمنطقة ، و بين العام 1916 ، الذي شهد زوال الاحتلال العثماني عنها .

تحمل حماه في تاريخها أيضا لقبان بارزان ، أولاهما ” مدينة النواعير ” الأداة التي ابتكرها الحمويون لرفع الماء من سرير نهر العاصي المنخفض إلى الأراضي المرتفعة بمنسوب يصل في بعض الأحيان إلى عشرات الأمتار ، واللقب إياه جاء نتيجة للتداعيات العميقة التي خلفتها تلك الطريقة الفريدة في الوجدان والنفس الحمويين حتى باتت محددة للكثير مما يجري على ضفاف النهر بدءا من المزاج العام ثم وصولا إلى أدق تفاصيل الحياة المجتمعية ، وثانيهما مدينة ” أبي الفداء ” الذي حملته نسبة إلى الملك الأيوبي عماد الدين اسماعيل بن علي الذي حكمها ما بين 1310 – 1331 م ، ولقبه كان ” أبي الفداء ” ، حيث سيستطيع في غضون حكمه الذي استمر لعشرين عاما أن يظهر حالا من التماهي بين الحكم ( السلطة ) و الناس ( الزمان ) والمدينة ( المكان ) فاستحق أن يكون اسم مدينته على اسمه .
بدر الدين الحامد:
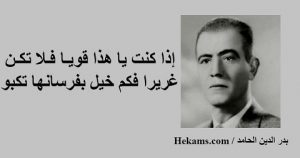
من مواليد حماة 1897 وفيها توفي 1961 ، لقبه الأشهر ” شاعر العاصي ” ، وفي سيرته أنه ولد في بيئة محافظة بدرجة زائدة نوعا ما ، لكن تلك البيئة لم تستطع قولبته وفقا لأقانيمها ، ولم تستطع كبح جماح التمرد فيه الذي تمظهر في ميله نحو مجالس الطرب والغناء ، بيد أن ذلك أدى به إلى حال من التناقض كانت واضحة في شعره الذي احتوى على عالمين ، أولاهما عالم الجد والرصانة ، وثانيهما عالم اللهو والمرح الذي ظهر عنده في شعر الغزل والخمرة وبعض التصوف ، لكن تلك العوالم ستشهد عنده منعطفا هو الأهم في حياته وشعره ، فعندما التهبت الثورة السورية بالتزامن مع عمليات ” تهويد ” فلسطين مضى في مسار شعري مواكب للحدثين ، وعبره ، أي عبر ذلك المسار ، جاءت أصدق أشعاره ، ولربما كانت قصيدته ” يوم الجلاء ” التي أطلقها بعد جلاء الفرنسيين من أكثر القصائد التي رددتها الأجيال حتى باتت منغرسة في الذات الجمعية للسوريين .
محسن البرازي:

سياسي و مفكر أكاديمي مواليد حماة 1904 ، أسس إلى جانب نخبة من المفكرين العرب ” رابطة العمل الوطني ” التي هدفت إلى مواجهة النفوذ الاستعماري الأوربي المتمدد في المنطقة ، أصبح مستشارا سياسيا للرئيس شكري القوتلي ، ثم تحالف مع حسني الزعيم بعد انقلابه على هذا الأخير آذار من العام 1949 ، وأصبح رئيسا لوزرائه قبيل أن يقضي معه بانقلاب سامي الحناوي شهر آب من هذا العام الأخير .
لعب دورا في الصلات التي أقامها الزعيم مع موشي شاريت ، وزير خارجية ( دولة ) الاحتلال ، بغية توقيع اتفاق سلام معها ، وكذا لعب دورا بارزا في تسليم انطون سعادة للأمن اللبناني بعد أن لجأ إلى دمشق في أعقاب أحداث الجميزة بعد أن منحه الزعيم حق اللجوء بل وأهداه مسدسه الشخصي عربون صداقة ، وبعد محاكمة صورية لم تستغرق لأكثر من 24 ساعة قامت السلطات اللبنانية بإعدام سعادة فجر 8 تموز 1949 ، الأمر الذي شكل بداية النهاية لعهد الزعيم .
يقول الضابط محمد معروف في كتابه ” أيام عشتها ” أن الضابط عصام مريود قام باعتقال البرازي في منزله ، وأنه توجه به إلى منزل أكرم الحوراني بدلا من أن يأتي به إلى مقر الأركان كما كان مقررا ، ويضيف هناك روايتان ، الأولى أن أكرم الحوراني قام بصفع البرازي و ركله برجله ثم طلب من مريود قتله ، والثانية أن مريود دخل على الحوراني في منزله وأعلمه أن البرازي معتقل معه في الخارج فطلب منه تصفيته ، وفي النهاية اقتيد البرازي إلى طريق المزة ، على أطراف دمشق بالقرب من مقبرة الفرنسيين فيها ، ثم جرى إعدامه رفقة حسني الزعيم فجر 14 آب 1949 .
وجيه البارودي:

ولد العام 1906 بحماة لأسرة موسرة و أباه كان محسوبا في مدينته على الوجهاء ، ولربما جاء التركيز في شعره على الغزل كنتيجة طبيعية للانتماء إلى تلك البيئة التي تشكل عاملا محفزا لرقي المشاعر والأحاسيس ، لكنه ذهب فيما بعد إلى نظم الشعر الذي يصنف في خانة الإصلاح الاجتماعي ، وهذا حدث ما بعد سني التعليم العالي التي قضاها في الجامعة الأمريكية ومن خلالها تعرف على الشاعرين الفلسطيني ابراهيم طوقان والعراقي حافظ جميل ، حيث سيساهم ذلك الثالوث ، الجامعة ورفيقاه ، في إكساب شعره نفحة وجدانية شابتها في كثير من الأحيان صبغة المعاناة التي لم يكن يعرفها سني الطفولة واليفاعة .
جهد البارودي خلال مراحل الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي على خوض غمار السياسة ومغامراتها إلا أنه لم ينجح ، ولذا فقد كرس حياته للشعر الذي تعددت أغراضه عنده بشكل يرسم ملامح الشخصية وتطوراتها ، ومن حيث التقييم يمكن القول أن البارودي كان ثائرا على التخلف و الجهل اللذان اعتبرهما حائلا دون نهضة بلاده ، وثائرا أيضا على قيم مجتمعه الذي يعاني الكبت والتزمت بقدر يحول دون انفتاحه و ركوبه موجة الحداثة ، وما يستحق الذكر هنا في هذا السياق هو أن البارودي ظل على وتيرته الثائرة ، التي باتت بأضعف الإيمان زمن الشيخوخة و انحصرت بأحاديثه في المجالس الخاصة التي رواها معاصرون عديدون عنه ، لا يحيد عنها إلى أن فارق دنيانا العام 1996 .
أديب الشيشكلي:

من مواليد حماة العام 1909 لكنه توفي بعيدا عنها في البرازيل عندما قام ” نواف غزالة ” باغتياله العام 1964 في مزرعته التي اشتراها بعيد خروجه من السلطة العام 1954 .
كان أديب ضابطا في جيش الشرق الذي أسسته فرنسا مطلع الثلاثينيات ، لكنه غادر ذلك الجيش ليلتحق بمعارك تحرير سوريا من الانتداب التي اندلعت في العام 1945 ، وفي معارك فلسطين كان على رأس لواء اليرموك الثاني التابع لجيش الإنقاذ الذي كان تحت قيادة فوزي القاوقجي ، وبعيد الاستقلال جرفته الأحداث التي عصفت بسوريا بدءا من انقلاب حسني الزعيم 1949 الذي كان قياديا فيه قبيل أن يعزله الأخير في سياق الاستقطابات الحادة التي كانت تعصف بالبلاد ، وصولا لمعاودة نشاطه بعيد انقلاب سامي الحناوي ، ومن ثم سيصبح بطل الانقلابين الثالث أواخر 1949 والرابع العام 1951 .
كان الشيشكلي قريبا من أفكار انطون سعادة في بداياته ، ثم مال إلى جمال عبد الناصر ، لكنه قرر ، في سبيل تثبيت سلطاته ، تأسيس حركة ” التحرير العربي ” التي استمرت حتى رحيله عن السلطة بعد ثلاثة أعوام من هذا العام الأخير .

تأثر الشيشكلي بأفكار الإصلاح الزراعي التي كانت تعني في تراجمها دخول شرائح واسعة من الفلاحين معترك الحياة السياسية ، لكن ذلك لم يمنعه ، بعد أن جرب متاهات السلطة عن قرب ، من أن يمسك بتلابيب الأخيرة بقبضة من حديد .
يروي هاني الخير في كتابه ” أديب الشيشكلي صاحب الإنقلاب الثالث ” أن استخبارات الشيشكلي كانت قد ألقت القبض على بائع مشمش كان ينادي ، في أحد أسواق دمشق ، للترغيب بسلعته التي يبيع ” عمرك قصير يا حموي ” ، لكن الإعلان ، الذي كان يهدف منه تذكير الزبائن بأن عمر المشمش قصير ، جرى تفسيره على أنه أبعد مدى من ذلك التذكير ما اقتضى اعتقاله و خضوعه للتحقيق .
أكرم الحوراني:

قد يكون الحوراني ، المولود بحماة سنة 1911 ، من أكثر الشخصيات إشكالية من بين كل من عرفتهم الحياة السياسية السورية في القرن العشرين ، ولربما كان ذلك ما يفسر الشهادات المتناقضة التي قيلت بحقه ، سواء أكان ممن عاصروه أم ممن عرضوا له بالتقييم والدراسة ، وصفه باتريك سيل ، صاحب كتاب ” الأسد والصراع على الشرق الأوسط ” ذائع الصيت ، بأنه ” القابلة التي ولدت على يديها سورية الحديثة ” ، وقال عنه كامل مروة ، مؤسس وصاحب جريدة الحياة ذائعة الصيت أيضا أنه كان ” مع كل انقلاب ، وفي كل انقلاب ، وضد كل انقلاب ” ، وهذا بالتأكيد إذ يشير إلى ديناميكية الرجل لكنه يشير أيضا إلى تقلباته التي كانت من النوع الذي يضع العديد من إشارات الاستفهام حول جدلية العلاقة ما بين ” الشخصي ” و ” الوطني ” عنده .
بدأ الحوراني حياته عضواً بالحزب القومي السوري ثم أضحى مسؤول الحزب الأول بحماة ، وعندما زار انطون سعادة هذي الأخيرة سنة 1947 طلب الحوراني إليه تسميته كنائب للأمين العام بذريعة أن ذلك سيضعه في موقع أفضل لجهة توسعة قواعد الحزب عبر تنسيب المناصرين ، لكن سعادة أجابه: ” أنت يا أكرم منذ سنوات تشغل منصب المسؤول الأول للحزب في منطقتك فلماذا لم تستطع توسعة تلك القاعدة ، أنت يا أكرم تبحث عن المناصب ، ولسوف أترك لك فرصة الحصول على مناصب أعلى لكن في أحزاب أخرى ” ، ولقد صدقت نبوءة سعادة إذ لم يطل الوقت بالرجل حتى بدأت رحلة البحث عنده عما تضمنته تلك النبوءة ، ولربما كان الإنصاف هنا يقتضي القول أن الحوراني كان مالكا لرؤيا سياسية جيدة ، وفهما للمسألة الزراعية السورية لا يدانيه شك ، لكن ” هوى المناصب ” كان قد أصاب الرؤيا والفهم بتلوثات قادت نحو انحرافات لاحقة .
يحسب للحوراني أنه كان شديد الاهتمام بالحركة الفلاحية ، والمؤكد أنه كان الأقرب لقضايا الفلاحين ومناصرتها بعيدا عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية ، وفي هذا السياق كان له دور بارز في دخول الآلاف منهم سلك الدولة والجيش ، والمؤكد أنه كانت لذلك تداعيات هامة في الأحداث التي شهدتها البلاد بدءا من 8 آذار 1963 حتى اليوم ، لكن ذلك لا يلغي تقييما يقول أن العامل ” الشخصي ” البارز لديه كان قد لعب دوراً في تلك الأفكار والسياسات من دون أن يكون هو المحرك الوحيد لهذي الأخيرة .
خاص للسلطة الرابعة


